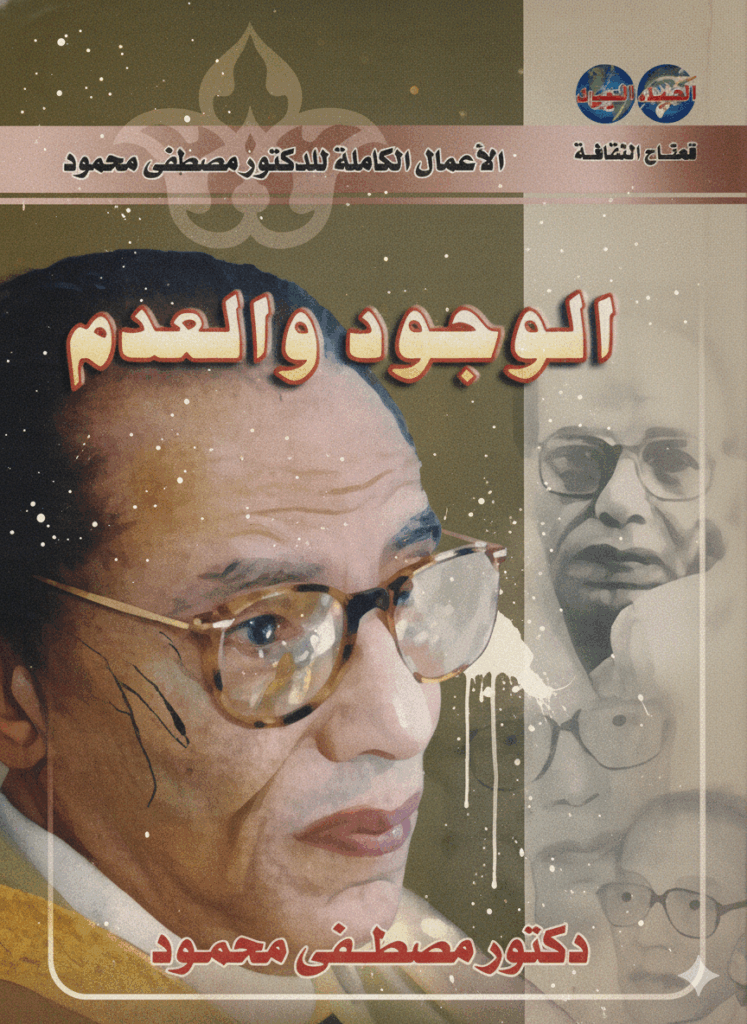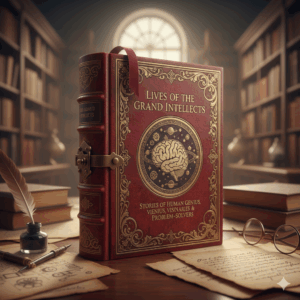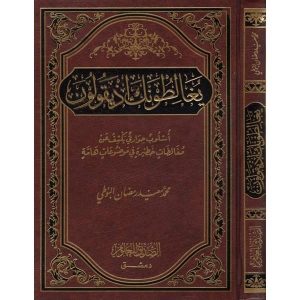التعرف على ملك الملوك: جوهر التوحيد وحرية الروح
تبدأ الرحلة بفهم القوة الحقيقية الوحيدة في الوجود، وهي قوة “ملك الملوك”. إن أساس هذا الفهم يكمن في إدراك الحرية المطلقة للروح البشرية. لا يمكن لأي سلطة أرضية، مهما بلغت من جبروت، أن تُخضع القلب أو الروح. قد ينجح السجّان في قهر جسد السجين، فيرغمه على توقيع ورقة، أو تقطيع الحجارة، أو حتى يقطع لسانه ، ولكنه يقف عاجزاً أمام تغيير ذرة كراهية أو حب في قلبه.
هناك في أعمق الأعماق روحٌ أعتقها الله من كل قيد ، حتى الشيطان نفسه لا سلطان له على عباد الله، إلا أولئك الذين اختاروا بأنفسهم اتباعه. هذا هو السبب الجذري وراء فشل كل النظم التي تعتمد على العنف والقهر في الإصلاح. فالقيم الحقيقية كالحب والشرف والإخلاص لا تُستخرج بالإرغام أو تُصنع بقرار وزاري؛ إنما هي “نبات رباني”.
هذا النبات الرباني لا ينمو ويزهر إلا حين يتوجه بكيانه كله إلى مصدر النور والطاقة، إلى ربه. هنا يتجلى المبدأ الأول: لا مصدر للحياة والحب والخير إلا الله. إن قول الله “لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا” ليس مجرد إعلان بالوحدانية، بل هو إعلان بأنه لا حاكم حقيقي ولا فاعل حقيقي سواه
التوحيد: رؤية العالم بعين الحقيقة
إن مفهوم التوحيد هو المبدأ الذي أُرسل به جميع الأنبياء ، وهو يعني أن الله وحده هو الضار النافع، المحيي المميت، المعز المذل. كل القوة والمواهب والحياة التي نمتلكها هي منه.
لفهم التوحيد بصورته العميقة، يجب أن نرى الله كفاعل حقيقي وراء “الأسباب” الظاهرة.
- الله هو الذي يروي وليس الماء؛ وهو الذي يُشبع وليس الطعام. الماء والطعام ليسا فاعلين بذاتهما، بل هي “أسباب” أقامها الله لمشيئته.
- التوحيد هو العمود الفقري الذي يحمل سقف الكون وسقف الشخصية الإنسانية. لو عبد الإنسان آلهة متعددة، لتوزع اهتمامه وتشتت وانقسم على نفسه.
- التوحيد يزيل الخوف من كل ما سوى الله. فلا تعود النار أو الحديد أو جبروت الحكام لها حقيقة بذاتها، بل هي مجرد “جنوده وأدوات مشيئته”. ولهذا يأمرنا الله: “فَلا تَخَافُوهُم وَخَافُونِ”.
يثور سؤال جوهري: إذا كان الله هو الفاعل الوحيد للضر والنفع، فما هو دور الأسباب الظاهرة كالميكروبات والأدوية والأطباء؟. الجواب هو أن هذه الأسباب لا تضر ولا تنفع بذاتها. الله هو الذي يملكها ويسخرها ، وهي لا تعمل إلا “بإذنه”. هو الذي أقام قانون السببية ، وهو القادر على تعطيله متى شاء، كما عطّل النار عن إحراق إبراهيم. لقد فهم إبراهيم هذه الحقيقة حين نسب الشفاء إلى الله وحده قائلاً: “وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ” ، بالرغم من وجود الأسباب الظاهرة للشفاء
الخلق والأمر: حينما تنسب الأفعال إلى الله
يمتد هذا المبدأ ليشمل كل شيء، حتى الأفعال التي يظن الإنسان أنه فاعلها.
التفسير هو أن الله هو الذي أمدنا بالعقل والفكرة والخامات، ورافقنا خطوة بخطوة حتى الإنجاز النهائي. فالفضل كله بيد الله
الأمر كله لله، حتى النبي نفسه قيل له: “لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ”. “أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ”.
حتى صنائع البشر تُنسب إلى الله. السفن التي يبنيها الإنسان، ينسبها القرآن إلى الله: “وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلامِ”.
نوح صنع الفلك “بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا”.
القرآن يتحدى الإنسان في صميم أفعاله: “أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ” ، “أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ”.
الاستعداد والقبول: كيف تمنح الهداية؟
إن الهداية والإيمان ليسا استثناءً من هذه القاعدة. فمقادير الإيمان بيد الله وحده، وليست بتأثير المعجزات أو الرسل. لو أن الله أنزل الملائكة وكلم الموتى، ما كانوا ليؤمنوا “إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ”. والنبي نفسه لا يهدي من أحب، “وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ”.
ولكن، هل هذا يعني أن مشيئة الله عشوائية أو تعسفية؟. قطعاً لا، وإلا لبطلت مسؤولية العباد. إن هداية الله وإضلاله تستند دائماً إلى “لياقة واستعداد في العبد”. العبد يملك المبادرة و”خلوص النية والتوجه” الذي يرشحه للعطاء أو الحرمان. فالعطاء الإلهي مشروط والحرمان مُسبب.
- “فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ” (عندما اختاروا هم الزيغ أولاً).
- “فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً” (زادهم بناءً على ما فيهم).
- “وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا” (جعلهم أئمة بسبب صبرهم).
- “اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ” (لعلمه باستعداد المحل).
القضية لها ظاهر وباطن. يستطيع الإنسان أن يخطو نحو النور فيتلقى النعمة، أو يرجع للظلمة فيصيبه الحرمان. لهذا، يبدأ الصوفية بتطهير الباطن فيما يسمى “إعداد المحل” ، ليصبح القلب أهلاً لتلقي “النفحات” الإلهية.
لا يمكن دعوة الملوك إلى مكان غير لائق؛ بل لا بد من فرش صالات الاستقبال. وهذا هو السر في أن الله ألقى برسالته إلى محمد عليه الصلاة والسلام. لم يكن ذلك تحيزاً، بل لأن “القلب المحمدي هو المحل الكامل” الذي أعده صاحبه وطهره، فأصبح ملائماً لنزول ملك الملوك.
التوحيد بين الفعل الإلهي واختيار الإنسان
إن مفهوم التوحيد هو موضوع دقيق وعميق ، وغالباً ما يبدو متصادماً مع الواقع المشهود. ففي حين يعلن الحق: “أَنَا الَّذِي أُحْيِي وَأُمِيتُ وَأَضُرُّ وَأَنْفَعُ” ، يرى الإنسان حوله قوى فاعلة متعددة: الرصاصة تقتل، والطبيب يشفي، والملوك تعز وتذل. يأتي السرد القرآني ليحسم هذا الأمر، فهو لا ينسب الأفعال إلا لله وحده؛ فلا يقول “نزل المطر”، بل “أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً” ، ولا يقول “هبت الريح”، بل “أَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ”. إنه يسند كل شيء، من الظواهر الطبيعية إلى هلاك الأمم، إلى الله كفاعل وحيد.
وهنا يبرز السؤال الأهم: إذا كان الله هو الفاعل لكل شيء، فماذا يبقى للعبد من فعل، وعلى أي أساس يُحاسب؟.
يأتي الجواب بالتمييز. أما كثرة الظواهر الطبيعية والملائكة، فهي تعمل بالتسخير والأمر الإلهي المباشر. إنها جنود مجندة ، وتعددها لا ينفي وحدة الآمر. وخير مثال على ذلك هو الموت، الذي يُسند تارة إلى “ملك الموت” ، وتارة إلى “رسلنا” (الملائكة) ، ثم في بيان الحقيقة المطلقة يُسند إلى الله: “اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ”. ولا يوجد أي اختلاف بينها، فالكل مظهر لمشيئة واحدة.
أما الجن والإنس، فالأمر مختلف. إنهم نفوس مُخيرة، تملك اختيار الطاعة أو المعصية ، ولذلك هي محل للمؤاخذة والحساب. والقرآن نفسه يسند الأعمال صراحة للعبد: “لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ” ، “كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ”. إذن، نحن أمام ازدواجية: الفعل يُسند لله ويُسند للعبد في آن واحد.
مفتاح هذا السر العجيب يكمن في آية واحدة: “وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى”.
- في هذه الآية، يُثبت الله الفعل للنبي: “إِذْ رَمَيْتَ”.
- وفي نفس اللحظة، ينفي عنه الفعل: “وَمَا رَمَيْتَ”.
- ثم ينسب الفعل الحقيقي لنفسه: “وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى”.
هذا يكشف أن للمسألة ظاهراً وباطناً. الظاهر أن أمامنا إرادتين، لكن الحقيقة أن الإرادتين تعملان في تطابق خفي. الله لا يُكره العبد على ما لا يريد، بل يختار له من جنس قلبه ويسهل له إنفاذ ما أضمر في نيته. فالله يقضي على العبد بما يطابق نيته. العبد ينوي، والله ينفذ له ما نوى، ولهذا يقع على العبد إثم نيته أو ثوابها. فالمحاسبة يوم القيامة هي “يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ”.
بهذا الفهم، يزول الخيط الفاصل بين التسيير والتخيير، فإذا بالتسيير هو عين التخيير، والتخيير هو عين التسيير. وعلم الله الأزلي باختيارات العبد لا ينفي حرية العبد، تماماً كما أن علمك المسبق بضعف ابنك في مادة لا يعني أنك أنت من أسقطته في الامتحان.
الوجود والعدم ووحدة الشهود
هذا الفهم العميق هو “توحيد أهل الأسرار” ، وهو يبدأ بسؤال أعمق: هل هناك ما سوى الله؟. الجواب هو نعم، هناك “العدم”. ولكن العدم ليس “لاشيء” مطلقاً، بل هو الوجه المقابل للوجود.
- الوجود (الله): هو الحضرة الموجبة، الفاعلة.
- العدم (السوى/الغير): هو الحضرة السالبة، القابلة. هو كالمرآة في مواجهة الشمس.
في هذا “العدم” تكمن حقائق أزلية قديمة ، هي “شئون الله”. نحن جميعاً كنا “حقائق في العدم” ، خصائصنا ملازمة لنا منذ الأزل، تتسم بالافتقار والاحتياج المطلق. والله برحمته أخرج هذه الحقائق من الظلمات إلى النور ، وأعطاها “لبسة الوجود” لتكون محلاً لتجلياته.
هذه الرؤية تؤسس “لوحدة وجود” إسلامية، لا علاقة لها بالـ “PANTHEISM” (وحدة الوجود الهندية). فهي لا توحد بين العبد والرب، ولا تدعي “أنا الله”. بل هي تؤكد أن العبد، حتى في وجوده، يظل حقيقته “عدماً” محتاجاً، وأن الوجود الحقيقي كله لله.
إن أقرب طريق لفهم هذه العلاقة هي معرفة النفس الإنسانية. فكما أن الله “ظاهر وباطن” ، فالنفس لها ظاهر وباطن. وعلاقة الروح بالجسد هي المثال الأعظم:
- الروح ليست “حالة” في الجسد ولا “متحدة” به.
- وهي ليست “متصلة” به (وإلا لنقصت ببتر عضو) ولا “منفصلة” عنه (وإلا لما كان الجسد أحق بها من غيره).
- للروح “قيومية” على الجسد ، كما أن لله قيومية على الكون.
وأقرب تشبيه للأمر هو تجلي الوجه في المرآة. ما تراه في المرآة هو “أنت” وفي نفس الوقت “ليس أنت”. أنت “موجود” في المرآة دون حلول أو اتحاد. كذلك يتجلى الله في المظاهر المختلفة دون أن يحل فيها. الله هو الوجه الواحد، والمرايا (المخلوقات) متعددة، وكل مرآة تعكسه بحسبها.
إن التوحيد مراتب:
- التوحيد اللساني: مجرد القول بـ “لا إله إلا الله”.
- التوحيد البرهاني: الاقتناع العقلي والتفكر.
- التوحيد كحياة وسلوك: أن تكون حياة العبد مطابقة لأمر الله، وتتوحد أقواله مع أفعاله ، كما في قوله تعالى: “قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ”.
- التوحيد الشهودي (الذروة): وهو “فناء” العارف بين يدي ربه. هنا لا يعود العارف يرى لنفسه وجوداً، بل لا يشهد إلا النور الإلهي. تنتهي الثنائية، ويعود العدم إلى العدم، ويبقى الله وحده لا سواه. هذا هو مقام “قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى”.
وبعد هذا الفناء، يرد الله للنفس “بقاءها”، وهو “البقاء بعد الفناء”. في هذا المقام، يصبح العبد مع الخلق لا تنقطع صلته بالحق، ومع الحق لا تنقطع معاملاته للخلق. إنه يرى الوحدة في الكثرة، والكثرة في الوحدة. وهذا هو “توحيد الأنبياء”.
حقيقة الخلق ومسؤولية الاختيار
إن الكون في حقيقته لا يحوي إلا “الوجود” (الله) و “العدم” (ما سوى الله). ولكن “العدم” هنا ليس “لاشيء” بالمعنى المطلق، بل هو “حضرة”. إنه “حضرة قابلة” أو “سالبة”، في مقابل “الوجود” الذي هو “حضرة فاعلة” أو “موجبة”. العلاقة بينهما كالفرق بين النور والظلمة، أو بين الشمس والمرآة التي يعكس نورها.
في هذا “العدم” تكمن “حقائق” أزلية، أو ما يسمى بـ “الأعيان الثابتة”. هذه الأعيان هي “أنا” و “أنت” و “نحن” ، وهي حقائق قديمة وأزلية “غير مجعولة” (أي غير مخلوقة في حد ذاتها). خاصيتها الأزلية هي الافتقار الكامل والاحتياج المطلق.
عملية “الخلق” الإلهي ليست إيجاد هذه الحقائق من لا شيء، بل هي إخراجها من حضرة العدم إلى حضرة الإمكان، وإعطائها “لبسة الوجود”.
حقيقة المسؤولية
هذا الفهم هو مفتاح فهم قضية الجبر والاختيار. فالله لا يقهر أحداً على غير طبيعته ، لأن هذه “الحقائق” أو “الذوات” قديمة وغير مجعولة. ما يفعله الله هو أنه يخرج نية العبد وسريرته (الكامنة في حقيقته الأزلية) إلى عالم التحقيق والواقع.
- العبد ينوي ويضمر ويتوجه بالإرادة.
- الله، بقدرته وقيوميته، يعينه على تحقيق ما نواه، سواء كان خيراً أم شراً.
- الله لا يغير حقيقة العبد، إلا إذا طلب العبد ذلك بنفسه، وأسلم ذاته مختاراً لربه.
علم الله الأزلي بهذه الذوات لا ينفي حريتها؛ فعلمه بها هو بما هي عليه في حقيقتها، وليس علماً يفرض عليها ما ليس فيها.
وحدة الشهود (الجمع والفَرْق)
إن الرؤية التوحيدية الكاملة، أو ما يسميه أهل الأسرار “أحدية الجمع والفرق” ، هي رؤية هذين الضدين في آن واحد.
- التنزيه (الفَرْق): أن الله “لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ”. وهو “الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ” ، المنفصل عن خلقه.
- التشبيه (الجَمْع): أنه “وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ”. وهو “مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ”.
العارف الحقيقي هو الذي يرى الوحدة في الكثرة، والكثرة في الوحدة. يرى أن كل المخلوقات، رغم ظهورها، لا تزال باقية على “عدمها الأصلي” ، وأن وجودها ما هو إلا استعارة وقرض مستمر من مدد “النفس الرحماني”. لو انقطع هذا المدد، لعادت المخلوقات إلى أصلها العدمي. فالمخلوق في حقيقته هو “ميت حي” في نفس الوقت
السير إلى الله: رحلة العارف
كل شيء في الكون، من الذرة إلى المجرة، في حالة حركة وسير دائم نحو غاية. هذه الحركة ليست عبثاً، فالله “لا يمكن أن يكون لاعباً نرداً بالكون”. والإنسان، كجزء من هذا الكون، كادحٌ إلى ربه “كدحاً فملاقيه” ، سواء أدرك ذلك أم جهله. العارف هو من يختار هذا السير بوعي وقصد.
باستخدام الصوفي “النفري” كدليل، يمكن تلخيص منازل هذا السير:
١. خلع النعلين
يبدأ السير بالأمر الإلهي “فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ”. النعلان هنا هما رمز لـ “النفس والجسد”. وخلعهما يعني “التجرد” عن التمركز حولهما والانخلاع من سيطرتهما.
٢. قطار “العِلْم” (المعرفة الظاهرة)
أول مركبة في الرحلة هي “العلم” (بمعنى المعرفة المكتسبة). لكن هذا العلم هو مجرد “مطية”. خطورته تكمن في أن يصبح هو الهدف، وهذا ما قصده القرآن بـ “يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا”.
- نهاية “العلم”: أقصى ما يصل إليه “العلم” هو اكتشاف أن الكون كله مخلوق من خامة واحدة، وبخطة واحدة، وقوانين واحدة . وهذا الاستنتاج يقود حتماً إلى أن خالقه “واحد”.
- عند هذه النقطة، يتوقف قطار “العلم”، لأن هذا “الواحد” لا يمكن إدراكه بالحواس أو رصده بالأدوات.
٣. قطار “المعرفة” (المعرفة الباطنة)
هنا، يجب على السالك أن يغير مركبته، من “العلم” إلى “المعرفة” (المعرفة اللدنية أو العرفان).
- العلم: يبحث في الكون، في الكثرة، في المادي. أدواته هي الحواس والعقل والتحليل .
- المعرفة: تبحث في المكوِّن (الله)، في الواحد، في الغيبي. أدواتها هي القلب والبصيرة والوجدان .
لركوب هذا القطار، يجب “الخروج من النفس”. وهذا الخروج ليس مجرد شعور، بل هو سلوك وعلامات:
- علامة الخروج عن علمك: ألا تقول “أنا عرفت”، بل “الله عرفني”.
- علامة الخروج عن عملك: ألا تقول “أنا أنجزت”، بل “الله وفقني”.
- علامة الخروج عن اسمك: ألا تجري خلف شهرة أو منصب.
٤. “الوقفة” (نهاية المعرفة)
رحلة “المعرفة” نفسها تصل إلى نهايتها حينما تصل إلى “الذات الإلهية”. هنا، تدرك “المعرفة” عجزها، ويدرك العارف أن “عجزه عن الإدراك هو عين الإدراك”.
- هذه المرحلة تسمى “الوقفة” ، أو الأدب.
- هنا يجب الخروج ليس فقط من النفس، بل من “الحرف والمحروف” ، أي من كل فكرة، أو معنى، أو خاطر، أو عبارة.
٥. “الرؤية” (مقام العبد الرباني)
عندما يخلو القلب تماماً من كل ما سوى الله، تأتي مرحلة “الرؤية” و “الحضرة”. في هذا المقام، يكون “ليس بيني وبينك أنت”.
- هذا هو مقام “العبد الرباني” ، الذي يقول عنه الحديث القدسي: “…كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها”.
- هو مقام عيسى عليه السلام حين أحيا الموتى “بإذن الله”.
- وهو مقام محمد عليه الصلاة والسلام حين رمى: “وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى”. العبد هنا يفعل بذات الله، لا بذاته.
تحذير: الشطحات والهذيان
هذه الحالة من القرب هي حالة “غيبوبة وذهول”. تسلب العقل وتذهب باللب. ومن هنا جاءت “الشطحات” التي ملأت كتب الصوفية.
- مثل قول البسطامي: “سبحاني ما أعظم شأني”.
- وقول الحلاج: “أنا الحق”.
- وقول الشبلي: “هل في الدارين غيري”.
هذه الأقوال هي من صنوف “التخليط والهذيان” ، وهي “سوء أدب”. يجب ألا تؤخذ كـ “حقائق عرفانية” بل كـ “وجدانيات”. فنحن لا نحاسب العاشق محاسبة علمية حين يقول لحبيبته “أنا أنت” ، والمشكلة أن الصوفي هو فنان وعاشق ورجل دين في آن واحد