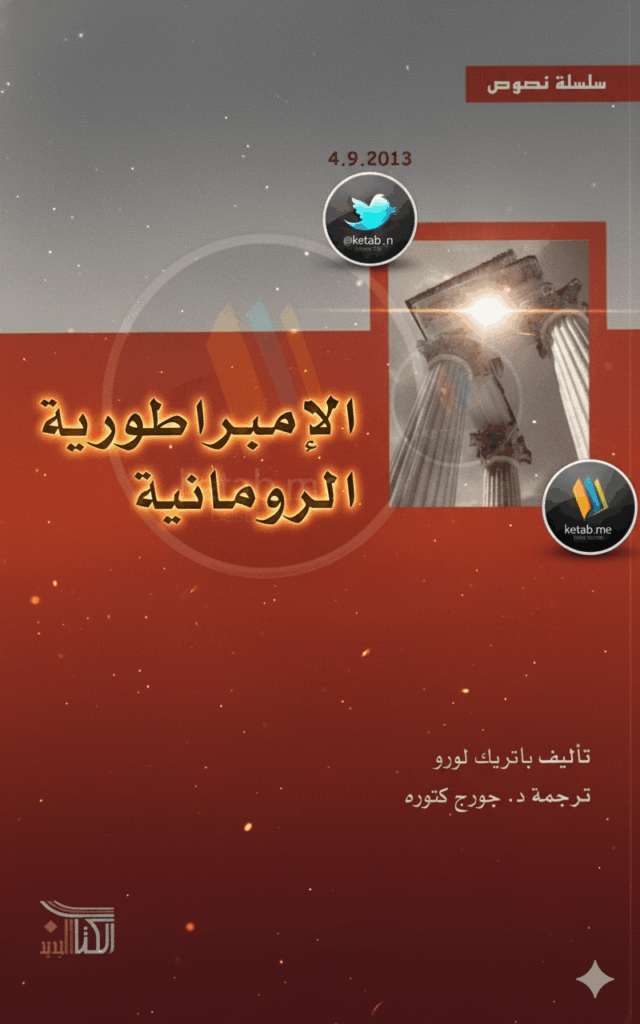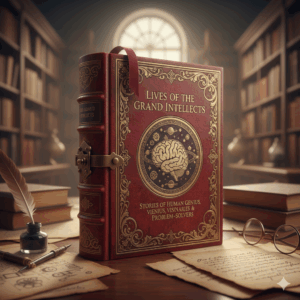ميلاد الإمبراطورية الرومانية وممارسة السلطة
يصعب تحديد الإطار الزمني الدقيق للإمبراطورية الرومانية؛ فعلى الرغم من أن ولادتها الرسمية تُؤرخ بعام 27 ق.م، فإن نهايتها تظل موضع جدل (سواء بسقوط روما عام 410 أو سقوط الإمبراطور عام 476). لكن جذور هذه الإمبراطورية تمتد إلى ما هو أعمق من ذلك، وتحديداً إلى “الجمهورية الإمبريالية” التي نشأت بعد الحرب البونيقية الثانية، والتي لم تكن لتقبل بوجود أي قوة منافسة لها. هذا الكيان الذي سيطر على العالم لقرون يظل بنية فريدة يصعب تصنيفها؛ فهي ليست مملكة هلينية، ولا دولة قومية، ولا ملكية مطلقة، ولا نظاماً شمولياً. إنها نموذج تاريخي حاولت الملكيات الأوروبية اللاحقة الإشارة إليه، لكنها عجزت عن إعادة إنتاجه.

إن فهمنا لهذه الإمبراطورية غالباً ما تشوهه المقارنات الحديثة الخادعة، كالإمبراطوريات البريطانية أو الفرنسية، أو “الإمبراطورية الأمريكية” في عصرنا. كانت الإمبراطورية الرومانية مزيجاً فريداً:
- مؤسسياً: هي شكل من أشكال ممارسة السلطة الملكية التي دمجت بين القيم الأرستقراطية التقليدية، والشرعية المستمدة من القانون العام، وبُعد ديني عميق.
- جغرافياً: كانت خليطاً من الحواضر والجماعات المحلية التي انصهرت في شبكة اجتماعية تراتبية.
- حضارياً: مثلت توسعاً للمواطنة الرومانية وحضارةً حملت قيماً نبيلة، لكنها في الوقت ذاته اتسمت بالعبودية، والمشاهد الدموية الوحشية، وانفلات العسكر.
إن كتابة تاريخها اليوم لا تعتمد فقط على المصادر الأدبية التقليدية (اللاتينية واليونانية)، بل على كنز من الوثائق المتنوعة تشمل المصادر القانونية، والنقوش، وأوراق البَرْدِيّ، والعملات، والدراسات الأثرية، مما يقدم رؤية أعمق وأكثر تعقيداً لعالم قد يبدو مألوفاً، لكنه في الحقيقة غريب عنا
الفصل الأول: الإمبراطورية أو قوة روما
1. النفوذ الروماني على العالم: من الجمهورية إلى القيصرية
لم تكن “قوة روما” وليدة عهد أغسطس (27 ق.م)، بل كانت موجودة قبله بعقود. فانتصارات الجمهورية المتوالية، خصوصاً تدمير قرطاجة عام 146 ق.م، خلقت قناعة لدى روما بأنها قوة لا تُقهر ولا منافس لها. لكن هذا التوسع بالذات هو ما فجر التوازنات الداخلية للجمهورية.
كانت الأزمة الأولى عسكرية-اجتماعية؛ فالجيش الروماني التقليدي كان يعتمد على تجنيد الفلاحين المالكين للأراضي. وعندما بدأ هؤلاء يفقدون أراضيهم (تحولهم إلى “بروليتاريا”)، اهتز أساس القوة العسكرية. جاءت “إصلاحات ماريوس” (107 ق.م) لتحل هذه المشكلة، حيث تحولت روما من نظام التجنيد الإلزامي القائم على الطبقات إلى “مبدأ التطوع الاختياري”. خلق هذا التحول نوعاً جديداً من الجيوش: قوات محترفة، متحركة، ولاؤها ليس للدولة بل لقائدها الذي يقودها للنصر ويوزع عليها الغنائم والأراضي. كان جيش قيصر في بلاد الغال هو النموذج الأبرز لهذا التحول. هذه الجيوش هي التي أشعلت الحروب الأهلية، وعندما عبر قيصر نهر الروبيكون عام 49 ق.م، لم يكن يعلن نهاية الجمهورية فحسب، بل كان يؤسس لمبدأ “القيصرية” (السلطة الإمبريالية) الذي ورثه عنه ابنه بالتبني، أوكتافيوس.
لم يأتِ عهد أغسطس بسلام دائم، فالحروب الأهلية كانت قد “أفسدت” التوسع الروماني ولم توقفه. ما تغير هو أن هذا التوسع أصبح الآن خاضعاً بالكامل لمراقبة “القيصر”، بدلاً من تركه لشهوات الجنرالات الطموحين. ففي ظل النظام الجديد، أصبح “السلم هو التوسع الإمبريالي” ذاته؛ روما، بوصفها وريثة اليونان وسيدة الأرض المسكونة، أصبحت الضامن للحضارة في وجه “البرابرة”. ورغم الكوارث (مثل كارثة غابة تويتوبورغ عام 9م )، استمرت الفتوحات:
- في العهد اليوليوسي الكلاودي (حتى 68م): تم ضم بريطانيا، ومناطق الألب، والبلقان (مثل بانونيا وميسيا وتراقيا)، وأجزاء من الأناضول، واليهودية، وموريتانيا.
- في العهد الفلافي والأنطوني (69-192م): تكثف النشاط العسكري. قاد تراجان (أول إمبراطور من أصول إقليمية) الإمبراطورية إلى أقصى اتساعها بضم داسيا (رومانيا حالياً) واحتلال أرمينيا وما بين النهرين (وهي مناطق تخلى عنها خليفته هادريان).
بدأ “العصر الذهبي” بالتحول إلى “عصر حديدي” في عهد ماركوس أوريليوس (161-180م)، الذي أمضى فترة حكمه في صد هجمات كارثية على الدانوب، ترافقت مع الأوبئة والمصاعب الاقتصادية. أدى جنون ابنه كومودوس إلى اغتياله عام 192 واندلاع حرب أهلية جديدة.
خرج سبتيموس سفيروس منتصراً (193-235م)، ليبدأ “عصر أسرة سفيروس” الذي اتسم بإعادة ترميم سلطة الدولة على حساب الأعيان، والتركيز المطلق على القوة العسكرية والمسائل الخارجية. لكن هذا النجاح كان مؤقتاً. فمنذ عام 235م (مع صعود ماكسيمين التراسي)، بدأ عصر “الأباطرة الجنود”. ولمدة نصف قرن (235-284م)، لم يمت أي إمبراطور في سريره. كانت هذه المرحلة سلسلة متصلة من الحروب الأهلية والاغتيالات، بلغت ذروتها الرمزية بـ “الأسر المخزي” للإمبراطور فاليريانوس على يد الفرس عام 260. هذه الفوضى هي التي مهدت الطريق لإصلاحات ديو قليطس، وأجبرت السلطة الإمبراطورية على التمركز والابتعاد عن روما، والبحث عن شرعية إلهية أقوى لضمان وحدتها.
الملكية في الممارسة: أسس نظام الحكم الإمبراطوري
كان نجاح أغسطس يكمن في تأسيس نظام حكم لا يعتمد على عقيدة واضحة أو دستور مكتوب، بل على شخصيته السياسية وقدرته على الموازنة. اكتسبت “الملكية الأوغسطية” مظهراً مزدوجاً:
- إخضاع الجمهورية: سيطر “الأمير الأول” (Princeps) على مؤسسات الجمهورية (مجلس الشيوخ، القضاة) دون أن يلغيها شكلياً.
- احتكار العائلة: استأثرت “عائلة القيصر” (Domus Augusta) بالسلطة الفعلية.
لم يكن هذا النظام استبداداً مطلقاً، بل كان على الإمبراطور دائماً أن يحسب حساب ردات فعل مجلس الأعيان (الأرستقراطية)، والعامة في روما، والأهم من ذلك كله، الجيوش في الأقاليم. كان “إجماع المواطنين” في كل أرجاء الإمبراطورية ضرورياً لاستمرار الحكم. نجح أغسطس لأنه قدم نفسه كـ “مُصالح” أعاد القيم الرومانية القديمة (mos maiorum)، بينما كان يرسخ سلطته وسلطة “بيته”.
كانت “العبادة الإمبراطورية” ركناً أساسياً. فبتأليه يوليوس قيصر، ثم منح أغسطس نفسه ألقاباً شرفية دينية في حياته، تمهيداً لتأليهه بعد وفاته عام 14م، أصبحت عبادة الأباطرة جزءاً لا يتجزأ من الديانة الرومانية العامة.
أثبت هذا النظام قدرته المذهلة على البقاء. فـ “التعود” على الحكم الإمبراطوري جعل النظام نفسه غير قابل للمساءلة، حتى في ظل أباطرة كارثيين. لم تكن وحشية كاليغولا أو جنون نيرون كافية لتهديد ما أسسه أغسطس. كانت المؤامرات (مثل اغتيال كاليغولا أو دفع نيرون للانتحار) تهدف لتغيير الإمبراطور، وليس لإلغاء الإمبراطورية.
الفصل الثاني: حكومة الأرض المسكونة
لم تكن الإمبراطورية الرومانية “دولة مركزية” ذات حدود ثابتة، بل كانت “إمبراطورية روما”؛ كياناً يتمحور حول مدينة واحدة هي روما، التي تمثل المركز والرأس المنظِّم للعالم. النظام السياسي الذي أقامه أغسطس كان يهدف لفرض “عقلانية جديدة” على العالم المعروف
. لقد كان تركيز السلطة المطلقة في يد رجل واحد هو الضمان الوحيد لانسجام هذا الجسد الواسع، الذي كان معرضاً باستمرار لخطر التفكك. هذه العقلانية الجديدة، القائمة على التقسيم والتصنيف والإصلاح المالي والإداري، كانت تمثل البحث عن “فن حكم صحيح” للأرض المسكونة.
1. الإمبراطور (Princeps)
شكل الإمبراطور، أو “الأمير الأول”، المحور الذي تدور حوله الإمبراطورية بأكملها. لقد استمد أوغسطس سلطته ليس فقط كـ “تفوق أخلاقي وديني” (Auctoritas)، بل كونه حصر لنفسه ولأسرته إرث التقليد الأرستقراطي.
الشعور الملكي: كانت الملكية الرومانية “ملكية شخصية” تعتمد على “الشعور” العام تجاه الحاكم. كان يُتوقع من الإمبراطور أن يتصرف كـ “أب” يقلق على أبنائه ويسعى لممارسة الفضيلة وتحقيق السعادة. لم تكن شرعيته نهائية؛ فإذا فقد شعبيته أو تكررت هزائمه العسكرية، كان عرضة للقتل. وبسبب ثقل المهام، اضطر الأباطرة مع الوقت لتقاسم السلطة باختيار “مساعد” (لقب قيصر) أو “زميل” (لقب أغسطس)
أسس سلطته: لم تكن سلطة الإمبراطور استبدادًا مطلقًا، بل استندت إلى مزيج معقد من الصلاحيات القانونية والدينية والعسكرية.
القوة السياسية والعسكرية (Imperium): احتكر الإمبراطور القوة العسكرية، وأصبح القائد الوحيد للجيوش.
القوة الخطابية (Tribunicia Potestas): من خلالها، كان يمثل “محامي العامة” في كافة أرجاء الإمبراطورية.
السلطة الدينية: بعد وفاة ليبيدوس، استحوذ الإمبراطور على منصب “الزعامة الدينية الكبرى” (Pontifex Maximus)، مما جعله محور الديانة العامة.
العبادة الإمبراطورية: لم يكن تأليه الأباطرة (الأحياء أو الأموات) يعني أنهم آلهة توازي جوبيتر، بل كان إقرارًا بـ “سلطة ما فوق بشرية” وتأكيدًا على أنهم “المختارون من قبل الآلهة” لضمان سلام الإمبراطورية.
وظيفته وممارسته للسلطة: كان الإمبراطور هو المدير الفعلي للدولة.
كان يدير الشؤون اليومية، ويستمع للعرائض، ويقيم المحاكمات، ويعتمد على مجلس من المستشارين والمكاتب الإدارية التي تعد له الملفات والقرارات.
أصبح الإمبراطور شيئًا فشيئًا “المصدر الوحيد للقانون”، متجاوزًا مجلس الشيوخ، وذلك عبر إصدار المراسيم والقرارات والخطب التي تكتسب قوة القانون.
كان يتم تصويره في التماثيل وعلى العملات بأشكال مختلفة لتعكس أدواره المتعددة: كقاضٍ يرتدي الثوب الفضفاض (Toga)، أو كقائد عسكري منتصر بالدرع، أو ككاهن يجسد التقوى.
2. العاصمة: روما
كانت روما هي المركز المطلق للإمبراطورية، “الرأس المرئي” الذي تتركز فيه كل خيرات العالم. ولضمان السيطرة على هذه المدينة الضخمة، تم إخضاعها بالكامل لسلطة الإمبراطور المباشرة.
- إعادة تنظيم المدينة: ألغى أوغسطس الإدارة الجمهورية التقليدية للمدينة وقام بإعادة تنظيمها إداريًا (14 منطقة و 265 حيًا).
- الإدارة الإمبراطورية: تم إنشاء وظائف جديدة (ولايات) يديرها مسؤولون يعينهم الإمبراطور مباشرة لضمان عمل المدينة:
- والي المدينة (Praefectus Urbi): قائد الشرطة النهارية والمسؤول عن النظام العام.
- والي الإطفاء (Praefectus Vigilum): مسؤول عن مكافحة الحرائق والحراسة الليلية.
- والي التموين (Praefectus Annonae): أهم منصب، وهو المسؤول عن ضمان “التموين بالحبوب” (الأغذية الأساسية) لحوالي 150,000 إلى 200,000 شخص كانوا يتلقون حصصًا مجانية، وهو أمر حيوي لضمان “السلم الاجتماعي”.
- “مدينة القياصرة”: تحولت روما إلى مسرح لعظمة الإمبراطورية عبر برامج بناء ضخمة. تم بناء “الميادين الإمبراطورية” (Forums)، والحمامات العامة الضخمة، والمعابد، والمسارح مثل “الكولوزيوم” الذي حل محل “بيت نيرون الذهبي” كرمز لعودة المساحة العامة للشعب.
- مباني الحكومة: لم يكن للحكومة حي إداري موحد. كانت وظائف الدولة، مثل مجلس الشيوخ (الكوريا)، ودور سك العملة، والأرشيف (Tabularium)، موزعة في أماكن مختلفة عبر المدينة، وغالبًا ما كانت تُدمج داخل المعابد والميادين العامة.
3. إدارة الأقاليم
كان التنظيم الإقليمي الجديد الذي وضعه أوغسطس يهدف في المقام الأول إلى “تحاشي المنافسة بين الأباطرة” (أي منع الحروب الأهلية) عبر احتكار القوة العسكرية.
- البعد العسكري: تم إنشاء جيوش دائمة ومحترفة تتمركز بشكل ثابت على الأطراف الحدودية للإمبراطورية (مثل نهري الراين والدانوب، وسوريا، ومصر). لم تكن هذه الحدود (Limes) خطوطًا دفاعية ثابتة بقدر ما كانت مناطق نفوذ ومراقبة.
- تقسيم الأقاليم: في عام 27 ق.م، تم تقسيم الأقاليم إلى نوعين رئيسيين:
- الأقاليم “القريبة من القناصل” (السيناتورية): هي الأقاليم الهادئة والقديمة التي لا تتمركز فيها جيوش (مثل أفريقيا وآسيا). كان يحكمها “قنصل قديم” يختاره مجلس الشيوخ.
- الأقاليم “الإمبراطورية”: هي الأقاليم الاستراتيجية التي تتمركز فيها الفرق العسكرية (الجيوش). كان يحكمها “مندوب” (Legatus) يعينه الإمبراطور مباشرة.
- مصر: كانت حالة خاصة، فهي إقليم إمبراطوري يُحكم من قبل “فارس” (Equestrian) وليس عضوًا في مجلس الشيوخ.
- “الحاكمون والمحكومون”: كان الهدف من الإدارة الجديدة هو إنهاء الاستغلال العشوائي الذي ساد في عهد الجمهورية.
- مهمة الحاكم: كانت مهام الحاكم الأساسية هي “ممارسة العدالة”، و”جباية العائدات” (الضرائب)، و”إقامة النظام”. وكان الجيش غالبًا ما يقوم بدور الشرطة.
- الإدارة المالية: كانت إدارة الضرائب والممتلكات الإمبراطورية منفصلة عن الحاكم، ويتولاها “مفوضون” (Procurators)، غالبًا من طبقة الفرسان.
- العدالة: كان القضاء جزءًا هامًا من عمل الحاكم، حيث كان يتنقل في “نواحٍ قضائية” (Conventus) لعقد المحاكمات.
- المجالس الإقليمية: كان سكان الأقاليم (النخب المحلية) يجتمعون سنويًا في “مجلس إقليمي” للاحتفال بالعبادة الإمبراطورية. وكان هذا المجلس يمتلك حقًا خطيرًا، وهو “تقديم الشكر” للحاكم المنتهية ولايته، أو على العكس، “تقديم الشكوى ضده” (ذمه) ومقاضاته أمام الإمبراطور في روما بتهمة الفساد أو سوء الإدارة.
الفصل الثالث: ثمانون مليون ساكن
تُقدّر أعداد سكان الإمبراطورية الرومانية في أوجها بحوالي ثمانين مليون نسمة ، موزعين على مساحة شاسعة تبلغ حوالي 10 ملايين كيلومتر مربع. لم تكن هذه الإمبراطورية كيانًا موحدًا، بل كانت بنية اجتماعية هرمية وأرستقراطية ، تستند في تنظيمها الأساسي على شبكة واسعة من “الحواضر” (المدن أو الكيانات السياسية المستقلة).
1. السكان والمجتمعات
لم تكن الإمبراطورية نسيجًا واحدًا، بل “موزاييك من الشعوب” يضم السلتيين، والبربر، والإسبان، والشعوب السامية، واليونانيين، وغيرهم. إن تحديد الأرقام الدقيقة للسكان أمر شبه مستحيل، حيث تتراوح التقديرات الحديثة بين 60 و 100 مليون نسمة. وكانت الظروف الديموغرافية هشة؛ فمتوسط العمر قصير ، والأمراض مثل التيفوس، والكوليرا، والطاعون، منتشرة وتحصد الشعوب بشكل دوري. أما الغذاء، فبينما كان اللحم نادرًا للأغلبية، اعتمد النظام الغذائي على الحبوب بشكل أساسي، مع مكملات من الفاكهة والمنتجات البحرية.
كان المجتمع الروماني مقسمًا بشكل صارم إلى فئات قانونية واجتماعية محددة:
- الأسرة (Familia): كانت الخلية الأساسية للمجتمع هي الأسرة النووية القائمة على الزواج الشرعي. كان الأب (Pater familias) يمتلك السلطة المطلقة على أولاده مدى الحياة. بقيت النساء والبنات في مرتبة أدنى قانونيًا من الأزواج والأبناء ، على الرغم من أن الأرامل كن يتمتعن بحرية أكبر في التصرف بإرثهن.
- العبودية: كان العبيد يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع، وهم نتيجة مباشرة لحروب الغزو الجمهورية. كان “العتق” (تحرير العبد) ممكنًا، لكنه لم يمنح حرية كاملة؛ فالعبد المُعتَق يظل مرتبطًا بسيده السابق ويحمل التزامات تجاهه.
- طبقة العوام (Plebs): شكل الفلاحون وسكان الأرياف ما بين 70% إلى 80% من إجمالي السكان ، وكان يُنظر إليهم غالبًا بازدراء باعتبارهم “برابرة”. وكانت “عامة روما” فئة مميزة عنهم، حيث كانت تتمتع بامتيازات خاصة مثل الحصول على توزيعات الغذاء المجانية.
- النخب (الأرستقراطية): كانت الثروة، وتحديدًا “ملكية الأرض”، هي الأساس الحقيقي للتصنيف الاجتماعي. انقسمت النخبة إلى طبقتين رئيسيتين:
- طبقة المشايخ (Ordo Senatorius): هي قمة الهرم الاجتماعي (حوالي 600 عضو بحد أقصى) ، وهي طبقة وراثية تتطلب حيازة ثروات عقارية هائلة (توازي 250 هكتارًا من الأرض).
- طبقة الفرسان (Ordo Equester): طبقة أرستقراطية ثانية (تضم 20,000 إلى 30,000 شخص) ، وكانت ثروتهم العقارية هي أساس مكانتهم. شكلت هذه الطبقة خزانًا يتم من خلاله ترقية الأعضاء الجدد إلى طبقة المشايخ.
أما النسيج الذي ربط هذه الطبقات المتباعدة فكان “نظام الزبائنية” (Patron-Client relationship). لم يكن هذا النظام مجرد إحسان، بل كان علاقة ثقافية عميقة ، حيث يقدم “الحامي” (Patron) الدعم والحماية لـ “زبائنه” (Clients) مقابل الولاء والخدمات، وكان هذا مصدرًا أساسيًا للمجد والشرف الاجتماعي.
2. إمبراطورية – عالم (اقتصاد الإمبراطورية)
شكلت الإمبراطورية “سوقًا ضخمًا ومنظمًا” يتركز بالكامل حول روما، التي كانت المستهلك الأكبر لخيرات العالم. كانت الدولة والإمبراطور هما اللاعب الاقتصادي الأكبر.
- أدوات الاقتصاد:
- العملة: قام أوغسطس بإرساء نظام نقدي موحد (الذهبي Aureus، الفضي Denarius، والبرونزي Sesterces) ، مما سهل المبادلات التجارية في كافة أنحاء الإمبراطورية.
- الضرائب: كانت عائدات الدولة تأتي من ضرائب متنوعة، أهمها ضريبة الأرض وضريبة الأشخاص في الأقاليم ، بالإضافة إلى ضريبة 5% على الإرث للمواطنين الرومان ، وضرائب غير مباشرة كالجمارك (2.5%) ومبيعات العبيد.
- دور الدولة: كانت المهمة الاقتصادية الأهم للإمبراطور هي تأمين “التموين السنوي” (Annona) لمدينة روما، خاصة القمح والزيت.
- عصر الازدهار (من أوغسطس إلى ماركوس أوريليوس): شهدت القرون الأولى للإمبراطورية ازدهارًا اقتصاديًا هائلاً. توسعت المدن، وانتشرت شبكات الطرق البرية والبحرية ، وسادت “الفيلا” (Villa) كمركز للإنتاج الزراعي المتنوع (حبوب، زيتون، كرمة) ، وازدهرت الصناعات التعدينية كالحديد في بلاد الغال.
- أزمات القرن الثالث: منذ عهد ماركوس أوريليوس، بدأت الضغوط العسكرية والسياسية في تفكيك هذا النظام. لمواجهة النفقات العسكرية المتزايدة، لجأت الدولة إلى “تخفيض قيمة العملة” بشكل متسارع. على سبيل المثال، قام كاراكلا بسك عملة “أنطونينيانوس” (antoninianus) التي كانت قيمتها الاسمية “دينارين” ولكن وزنها الفضي أقل بكثير. بحلول عام 260، انهار النظام النقدي فعليًا ، وتلاشت الفضة من العملات، مما أدى إلى تضخم هائل (قُدّر بـ 3% سنويًا) وانحسار شديد في المبادلات التجارية
3. حواضر بالآلاف (نظام المدن)
لم تكن الإمبراطورية تُحكم كوحدة واحدة، بل كانت “إمبراطورية من الحواضر”. كانت “الحاضرة” (Civitas) – أي المدينة ومحيطها الريفي – هي الوحدة الأساسية للحكم الذاتي، والخلية الجوهرية التي شكلت قوام الإمبراطورية.
- التراتبية القانونية للمدن: لم تكن جميع الحواضر متساوية، بل خضعت لتراتبية قانونية دقيقة:
- في الغرب اللاتيني: كان “القانون اللاتيني” (Ius Latii) يمنح سكان الحاضرة حقوقًا تمهيدية، قبل الوصول إلى مرتبة “المستلحقة” (Municipium) أو “المستعمرة الرومانية” (Colonia) التي تتمتع بكامل حقوق المواطنة.
- في الشرق اليوناني: احترمت روما التقاليد العريقة للمدن اليونانية (Poleis). لم تفرض عليها النظام اللاتيني، بل تركتها “مدنًا حرة” (Civitates liberae) تحكم نفسها بمؤسساتها الخاصة.
- السياسة المحلية: كانت كل حاضرة بمثابة “روما مصغرة”. كان الحكم فيها أرستقراطيًا ، ويديره “المجلس” المحلي (يُعرف بقادة العشرة) الذي يضم أغنى أعيان المدينة مدى الحياة.
- الكرم الفردي (Evergetism): كانت الحياة المدنية قائمة على “سخاء” الأعيان. كان يُتوقع من النخبة المحلية تمويل الأبنية العامة، والألعاب، والمهرجانات، والحمامات، وتوزيع الغذاء على نفقتهم الخاصة. كانت هذه هي الطريقة التي يكتسب بها الأعيان الشرف ويحافظون بها على سلطتهم.
- “حب الوطن” (Philopatris): كانت الهوية الأقوى لسكان الإمبراطورية هي “الوطنية المحلية”. كان الفرد يشعر بالانتماء أولاً وقبل كل شيء إلى حاضرته أو مدينته الأصلية (وطنه)، وليس إلى روما كـ “وطن كوني”. كانت هذه الحواضر المستقلة ذاتيًا، والمرتبطة بهويتها المحلية، هي التي تشكل في مجموعها الإمبراطورية التي يعيش فيها 80 مليون ساكن.
خص الفصل الرابع: الإمبراطورية التي نحن بصددها
لم تكن الإمبراطورية الرومانية نموذجًا للعدالة أو الوحدة الإنسانية المثالية. لقد استندت السيطرة الرومانية على عدم مساواة صارخة؛ فالعبودية استمرت وازدهرت دون التفكير في إلغائها ، وعاش معظم الناس في فقر، وعوملت النساء كأقليات. ومع ذلك، فإن قوة الإمبراطورية لم تكمن في فرض ثقافة واحدة بالقوة، بل في تعقيد التفاعلات الثقافية ومسألة الهوية، وفي كيفية تعاملها مع التمرد الداخلي والتهديد الخارجي.
الهويات والامتزاجات
لم تكن “الرومنة” (Romanization) سياسة استعمارية تهدف إلى محو الشعوب الأصلية، بل كانت عملية تفاعل ثقافي معقدة.
- التحولات الثقافية: إن التحول إلى “روماني” لم يكن مفروضًا، بل كان خيارًا تبنته النخب المحلية والشعوب في الأقاليم. ويظهر هذا التحول بوضوح في الثقافة المادية: فانتشار السيراميك، والحمامات، وأنماط العمارة، وحتى العادات الغذائية الجديدة، كان انعكاسًا لتبني أسلوب حياة جديد جاء معه علاقات اجتماعية وأذواق متغيرة.
- هويات جديدة: لم يعنِ تبني الثقافة الرومانية التخلي عن التقاليد الموروثة. بل أدى ذلك إلى خلق “هويات مزدوجة” أو جديدة؛ فالمرء لم يكن يتخلى عن كونه “غاليًا” أو “إسبانيًا”، بل أصبح “غاليًا-رومانيًا” أو “إسبانيًا-رومانيًا”. كان هذا الاندماج طوعيًا في الغالب، حيث رأى سكان الأقاليم أن في هذا التحول فائدة لهم.
- الحالة اليونانية الخاصة: شكل اليونانيون حالة فريدة. فبينما اندمجوا سياسيًا في الإمبراطورية، ظلوا متمسكين بتفوقهم الثقافي (الهللينية) ولغتهم وتقاليدهم العريقة. لقد نجحت نخب الحواضر اليونانية في التكيف، فاستخدموا لغتهم الخاصة ومفاهيمهم لوصف السلطة الإمبراطورية، ودمجوا عبادة الإمبراطور ضمن تقاليدهم الدينية.
مسألة التمرد
واجهت الإمبراطورية تحديات داخلية مستمرة، لكن هذا التمرد نادرًا ما كان ذا طابع “قومي” أو “انفصالي” يهدف للاستقلال.
- التمرد الضريبي والاجتماعي: كانت أغلب الثورات الكبرى رد فعل على ضغوط محددة، وليست رفضًا للوجود الروماني بحد ذاته.
- ثورات الغال: لم تكن ثورات مثل ثورة “فيندكس” (Vindex) عام 68م بدافع الحنين للاستقلال الغالي، بل كانت رد فعل عنيفًا من النخب على السياسات الضريبية القاسية التي فُرضت منذ عهد أغسطس (مثل ضريبة الأربعين مليون سترس).
- ثورة أفريقيا (238م): بالمثل، كانت الثورة التي قادها “الغورديانيون” (Les Gordiens) في أفريقيا تمردًا قام به كبار ملاك الأراضي الأثرياء ضد الإجراءات المالية القاسية التي استهدفت ثرواتهم.
- اللصوصية والاغتصاب العسكري: اتخذت المقاومة أشكالًا أخرى. “اللصوصية” (Banditry)، مثل حركة “ماترنوس” (Maternus) الذي كاد أن يقتل الإمبراطور كومودوس، كانت غالبًا تمردًا اجتماعيًا للفقراء والمهمشين ضد الأغنياء وممثلي السلطة. أما “الاغتصاب العسكري”، مثل تمرد “أفيديوس كاسيوس” (C. Avidius Cassius) ضد ماركوس أوريليوس، فلم يكن سوى محاولة من قائد طموح للاستيلاء على العرش، مستغلاً ولاء جيشه.
- التحدي الديني (اليهود والمسيحيون): شكلت هاتان المجموعتان تحديًا أيديولوجيًا فريدًا:
- اليهود: كانت علاقتهم بروما سلسلة من المواجهات العنيفة (مثل ثورة 66-70م وثورة الشتات 115-117م). لم يكن الصراع مجرد رفض للحكم الأجنبي، بل صدامًا أيديولوجيًا عميقًا. التوحيد اليهودي، والآمال المسيحانية، والشعور بالخصوصية الدينية، كلها عوامل اصطدمت بشكل مباشر مع تعدد الآلهة الرومانية وعبادة الإمبراطور، مما أدى إلى حروب إبادة وتدمير المعبد.
- المسيحيون: في البداية، كانوا يُعتبرون فرقة يهودية. لكن الصدام حدث لأن المسيحيين رفضوا المشاركة في الديانة العامة للإمبراطورية، وتحديدًا “عبادة الأباطرة”. لم يُنظر إليهم كأتباع دين مختلف فحسب، بل كـ “ملحدين” يهددون “سلام الآلهة” (Pax Deorum)، وبذلك يهددون سلامة الدولة نفسها. كانوا بمثابة جماعة سرية تعمل خارج القانون.
مسألة “من هم في الخارج”
شهد القرن الثالث تحولًا جذريًا في علاقة الإمبراطورية بجيرانها، الذين يُطلق عليهم “البرابرة”.
- تحول الحدود (Limes): مالت حدود الإمبراطورية، التي كانت في السابق مناطق توسع، إلى الانغلاق لتصبح “خطوطًا دفاعية” ثابتة (مثل جدار هادريان).
- التهديدات الجديدة: لم تعد الهجمات مجرد غارات متفرقة، بل أصبحت هجمات متزامنة ومنسقة من قبل تحالفات قبلية جديدة وقوية (مثل القوط، الفاندال، والفرنجة) على جبهات الراين والدانوب والفرات.
- سياسة “التهجير والاستقبال”: عجزت الجيوش الرومانية عن صد هذه الموجات، فلجأت الإمبراطورية إلى سياسة جديدة: “استقبال” (Reception) “البرابرة”.
- بدأ الأباطرة، مثل بروبوس (Probus)، في توطين أعداد كبيرة من الشعوب المهزومة (مثل الألمان) داخل أراضي الإمبراطورية.
- كان الهدف هو إعادة إعمار الأراضي المهجورة وتزويد الجيش بمجندين جدد.
- كانت هذه السياسة حلاً يائسًا، لكنها غيرت تركيبة الجيش والمجتمع الروماني بشكل جذري، حيث أصبح “البرابرة” جزءًا لا يتجزأ من الدفاع عن الإمبراطورية التي استقروا فيها.
خلاصة الكتاب
على الرغم من الانقسامات العميقة، والتناقضات، وحالات العنف واللامساواة، نجحت الإمبراطورية في خلق “حضارة رومانية” (Romanitas). هذه الحضارة لم تكن مجرد قوة عسكرية، بل كانت نظامًا قانونيًا ومؤسساتيًا وثقافيًا (يُعرف بـ Humanitas). لقد وفرت إطارًا مشتركًا سمح لثمانين مليون شخص من أعراق وديانات مختلفة بالانتماء إلى كيان واحد، وهو ما منح الإمبراطورية قدرتها الهائلة على البقاء والمقاومة رغم كل التحديات.